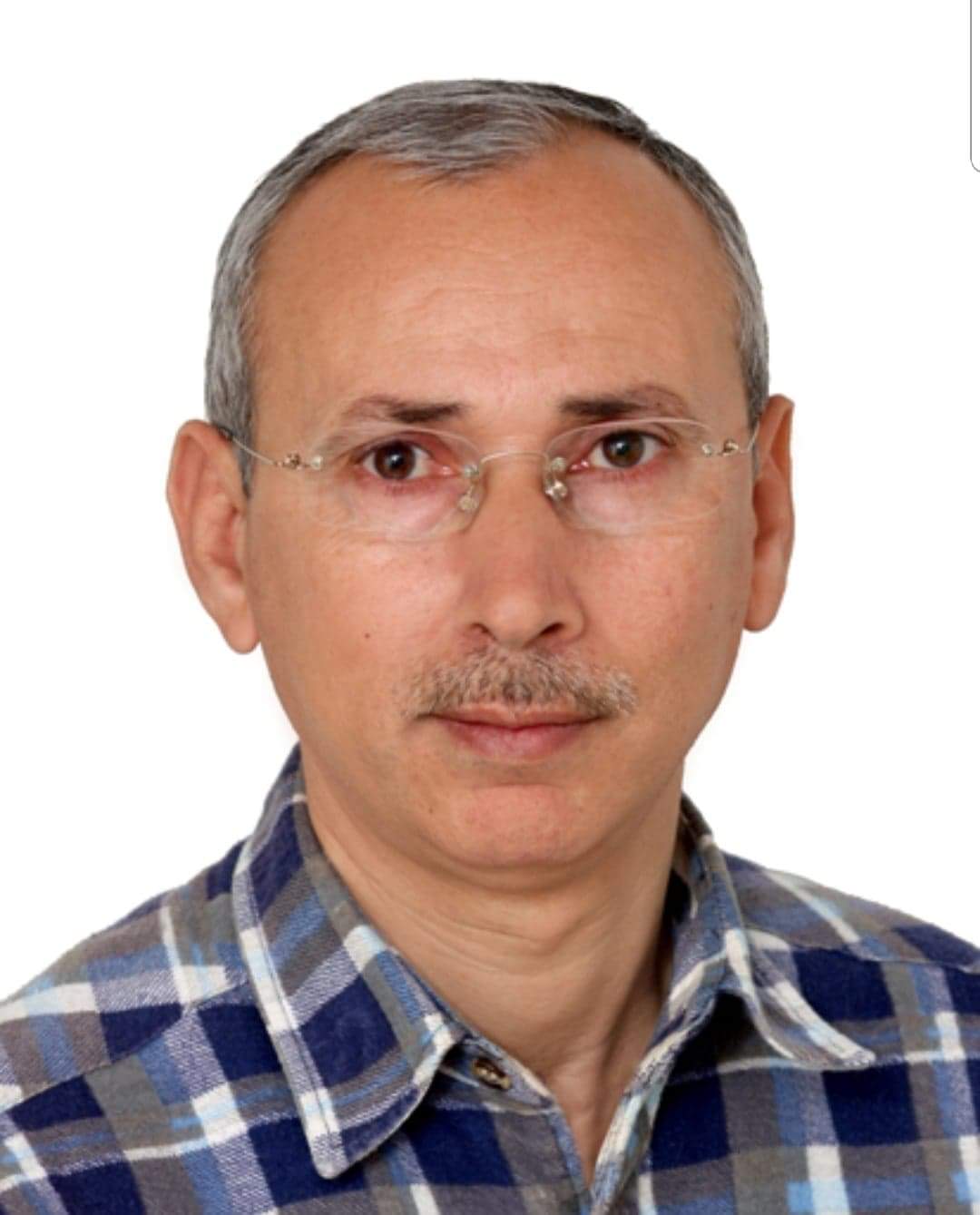عام مضى ولفظ أنفاسه الأخيرة، وحل عام جديد، إلا أن عام 2018 الذي ذهب كان عاماً شديد القسوة على الشعب العربي في عدة بلدان. إنه عام التعذيب الشعبي الذي اتخذ شكلا درامياً سيتجاوز بمئات المرات أي ملحمة قد تكتب عن عام بلغ فيه الضجيج أقصاه، ووصلت الحرائق فيه إلى النفوس قبل أن تبلغ أي مكان آخر، وأن هذه النفوس التي تستعيد اليوم أنفاسها ستجد نفسها بعد مدة ليست بقصيرة أن ما دفعته من أجل غدها وما وعدت به لم يحصل وقد لا يحصل، حيث جميع العوامل تؤكد المسيرة السائرة نحو غايات مختلفة، لأن من خطط وموَّل أراد شيئاً آخر لتلك الشعوب المسكينة التي صدقت الدعوات، بعدما اخترقها الإعلام مثل رصاصة مرت قرب الرأس لم تقتل صاحبه لكنها خلخلته.
فمن بلاد الشام إلى بلاد الروهينقا، مروراً بالعراق وأفغانستان وفلسطين ولبنان وسوريا واليمن ومصر وليبيا وتونس… يغص المشهد بألوان الدم والدخان، وبالقتل والحرائق وبيارق الفرق المتناحرة… وتضج الأنفس بالشكوى من أشكال الظلم والقهر والجوع والرعب، ومن انحطاط أخذ يتفشى ويتفتق عن مكائد وسموم في سياسات وكتابات ووسائل إعلام بلغ بعضُها درجات من التحلل والانحلال والتهافت والتهالك على الصغائر والمهالك..
اليوم، فالخراب الذي ينتشر في دول ما يسمى ”الربيع العربي” يوضح أن ما شهدته وتشهده ليس بثورات وإنما تآمر مفضوح يهدف إلى تهديم المجتمعات العربية وتفكيك روابطها، والعودة بها إلى الدرك الأسفل من مراحل تطور البشرية، ومن ثم تكريس الاستباحة الأمريكية والإسرائيلية، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. فعندما تخسر المجتمعات أمناً يؤمن لها أيامها ولياليها ليصنع لها صحة جيدة، فإن عليها أن لا تثق بمؤسسات ودساتير وقوى نظامية، وبالتالي مستقبلا لا مستقبل له.
وضوح العام الذي مر يأخذنا إلى مرحلة أخرى أعتقد أنها تخطت الممولين والمخططين والمراهنين، وهو أن قادة سقطوا لكن شعوباً لم تسقط، فهل المطلوب في مرحلة لاحقة إسقاط الشعوب كي نأمن التاريخ بكل أبعاده المقبلة. ثم إن هنالك قادة وشعوباً لم يسقطوا فهل بإمكانهم إسقاط التاريخ والحاضر والمستقبل؟ هل يمكن الاعتداء على التاريخ كي نسقطهم جميعا لتحقيق غاية أو غايات…؟
الأمة العربية كلها اليوم مستهدَفة باستهداف أقطار من أقطارها، أو فئات منهم داخل أقطارهم، وما يحدث في الدار، ينتقل للجار… وهكذا وهكذا… فالحبلُ على الجَرَّار. النار اليوم في سوريا وفي العراق، وفي اليمن، وفي ليبيا… وغداً، وغداً؟! اليوم وغداً، فلا ندري على من سيكون الدّور غداً.
لقد غاب ـ أو يكاد ـ العقل السياسي العربي، وغابت معه لغته وفطنته وحضاريته وفاعليته، فيما اكتظت المنابر والميادين والفضائيات بالخطابات الغوغائية، والفتاوى التكفيرية، والثقافات البدائية، والجماعات الإرهابية المتعطشة للدم، والمتفرغة للقتل والذبح، والمتخرجة من مسالخ تنظيم القاعدة الذي استعاد سيرته الأولى في خدمة المشاريع والمخططات الأمريكية والصهيونية، وبات يشكل مع أفرعه وأذرعه المتناسخة (جبهة النصرة، داعش، الجبهة الإسلامية…) خطراً داهماً على الأمن القومي برمته والمستقبل العربي بأسره.
أما أسباب هذه الحالة العربية المتردية جداً فهي متعددة وواضحة ومنها على سبيل المثال:
ـ مخطط التجزئة والتفتيت الذي ضرب الأمة العربية بعد الحرب العالمية الأولى ومن ثم بعد الحرب العالمية الثانية، وما تبع ذلك من تبعية مطلقة للعديد من الدول العربية للخارج من النواحي السياسية والاقتصادية.
ـ الاستعمار بشكليه القديم والجديد الذي يبحث بالشمعة ـ كما يقال ـ عن أي ثغرة ينفذ منها لزيادة الانقسام العربي، ”وما أكثر هذه الثغرات” مع كل أسف…
ـ الأنظمة العربية الاستبدادية التي رعت وأنتجت حركات متطرفة مثل الوهابية التكفيرية وغيرها تشوه الدين والجوانب الناصعة من حضارة العرب والمسلمين.
إثارة النزعات المذهبية التي ضربت الكل بالكل ولم تقتصر على فئة من دون أخرى ناهيك بالنزعات العرقية والطائفية والعشائرية الضيقة.
ـ الفساد المالي الذي استشرى في معظم الدول العربية في ظل غياب القضاء العادل والمساءلة والمحاسبة القانونية.
ـ صفقات السلاح الضخمة التي تشتريها بعض الأنظمة الحاكمة ولاسيما في بعض دول الخليج لحماية نفسها وليس لحماية البلاد من التهديدات الخارجية…
لقد كتب الكثير وسطرت ملايين الصفحات، إن لم يكن أكثر تشخيصاً وقراءة للواقع العربي… وكان الجميع يقف أمام السؤال المهم والمزمن عن كيفية الخروج من حالة الانقسام والتردي، بعدما نجح الغرب في تجاوز أزماته وتقدم، بينما بقي معظم العرب يستوردون كل شيء. والسؤال الجوهري هو أنه ما دامت أسباب حالة التردي هذه معروفة ـ كما أسلفنا ـ فلماذا انعدمت الحلول للمشكلات العربية؟.
يقول العديد من المؤرخين ومتابعي الشأن العربي: ”إن الكثيرين من العرب مازالوا وهم في مطلع القرن الحادي والعشرين، محكومين بالماضي”، بمعنى أن كل شيء يفسرونه ويبتون فيه على ضوء معايير تنتمي إلى الماضي والتاريخ السالف، فالحل الذي وجد لمشكلة في صدر الإسلام أو في العهود الأموية والعباسية، يعتقدون أنه مازال صالحاً لحل المشكلات التي تواجههم في العصر الحديث، ويعتقدون أيضاً أن الحلول الجاهزة موجودة في كتب التاريخ والتراث ويحاولون إسقاطها على الواقع الحالي… ومع ذلك فإنهم مازالوا غارقين في حفر عميقة من الآلام والدم والخراب، وعلى سبيل المثال: السلفية عادت بمقولات وخطاب تجاوزهما الزمن والعقل، ونشط دعاة الانكفاء على الذات ودعاة الماضوية القائلين:
”إن الماضي خير من الحاضر والمستقبل، لأنه مثال الأمن والطمأنينة”، كل هذا أدى إلى ظهور المنظمات الإرهابية المتطرفة التي يأتي على رأس أولوياتها إقصاء الآخر أو حتى التخلص منه على أساس أنه ”كافر ومرتد” على النحو الذي يمارسه تنظيم ”داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية، كذلك كتب الكثير عن عجز معظم الأنظمة والشعوب عن توحيد، ولو في الحد الأدنى، لأجزاء من وطننا العربي الكبير، وعن ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية والتطلع إلى خارج الحدود للاستعانة بالأجنبي، وعن ضرورة الاستقرار أولاً قبل التقدم والحريات والديمقراطية، ولكن بقي ما كتب حبراً على ورق.
وليس من الغريب أن تبدو السياسات الصهيوأميركية الدافعة لهؤلاء العرب المعنيين واضحة، فالسياسة لا تزال هي السياسة، والعمالة عند بعض الأعراب لا تزال هي العمالة، وتشعر أمام هكذا واقع، أن عالمنا العربي على الخصوص وبعض جواره الإسلامي لم يعد فيه سوى هذه المستويات المتدنية من السقم الفكري والسفاهة اللفظية والانحدار ورسوم الأدعياء و ”عملقة” الدعاة من كل نوع: من دعاة الحروب المذهبية والطائفية والعرقية إلى دعاة الاستعمار والصهيونية والحزبيات الضيقة والأيديولوجيات الغريبة المريبة، ومن دعاة الشرذمة والتقسيم السكاني والجغرافي، والفيدراليات السياسية الهزلية… وكل من ذلك وأولئك يعيدنا عهود ـ ”ما قبل عقلانية وما قبل جاهلية وما قبل حضارية..؟! ”.
ويضاف إلى ذلك دعاة بمعاول صلف وجهل يريدون هدم صرح العروبة التي يتهمونها بما لا يصدق ولا يطاق، وهدم الإسلام المحمدي الصحيح ومحاولة تشويه صورته النظيفة الناصعة، ونقض معمار قيمه ومقوماته وتسامحه ونقائه البهي… إذ تستمر الحملات على الدين ”الإسلام”، فمِن مطالِب ”بتجديد الإسلام”، إلى منادٍ ”بتخليصه من التطرف والتعصب، ومما يقولون إنه يشجع على الإرهاب؟!، إلى مستظرف لنفسه، معجب بعقله، يلطف الأمر إلى تغيير التفسير، لكي يتلاءم مع متطلبات من يرون في الإسلام ما يرون، ويتهمونه بما يفترون عليه. وكأن الإسلام ”مسوَّدة” يعيدون كتابتها، وتصحيحها، وتعديلها، وفق الطلب؟! وأولئك الذين من بينهم من العرب والمسلمين، حالهم حال مَن يوحون إليهم… يحيلون فعل أي مسلم، مهما كانت ظروفه وأسبابه وبيئته وشخصيته ونفسيته وحالته العقلية، وجنسيته… يحيلون كل فعل على الإسلام، فيشيرون إلى من يقوم بعمل إرهابي مدان، بأنه ”إسلامي، مسلم”، أما من يقوم بعمل إرهابي من غير المسلمين، فلا يُنسَبُ إلى دينه، ولا حتى إلى جنسيته، وقد يُغفل اسمُه.
وهناك من يعترض بوقاحة، على تقارب أي دولتين إسلاميتين، بينهما خلاف… لأن المطلوب، بنظر أولئك المعادين، أن يستمر الخلاف ويتطور، لنزداد نحن ضعفا وتبعية، وليتمَّ تمزيق شعوبنا وأوطاننا. وهذا السطح الذي يظهر للعالمين اليوم ويتلامع ربما دل على قمة جبل الجليد من مآسينا المتعددة الألوان والأسباب، وعلى عمق الانحطاط والانحلال والانفلات الذي بلغناه وأوصلتنا إليه سياسات ومؤامرات ومصالح وثقافات ووسائل إعلام تضليلية موجهة ودعاة تحت الطلب.
عام 2018 كان في غاية الوضوح بحيث تجلى فيه من يخطط، ومن يدفع المال، ومن يراهن، ومن يفترض سقوطه… فالذين دفعوا وما زالوا الأموال على إسقاط الأنظمة، حجبوا بكل أسف ولو جزءا منها عن إمكانية التنمية في العالم العربي… والذين خططوا، هم من كانت لديهم الأفكار القديمة باغتيال العالم العربي في كل مرة تنمو فيه رغبة في التغيير، إعطاؤه جرعة من التغيير لكن تحت الكنترول. أما المراهنون فهم الصامتون الذين لا نفهم منهم إذا كانوا يقبلون بدور الممولين على المديين القريب والبعيد. ولكن، يجب التنبه له، أن الولايات المتحدة وكل أذرعها الإسرائيلية والغربية، لا تقبل نظاماً له كل هذه المهمات كي يخرج بأقوى مما تتحمل المنطقة مع أنه أصغر من خرم إبرة.
لقد كان الدور الغربي حاسماً في تسريع وتيرة الفوضى حيث وجد من الناحية الاجتماعية أو ما يعرف بالمجتمع المدني الذي كانت مكوناته يملأ أفئدتها الحنق والغضب من مظاهر الظلم والفساد، وتركز الثروة بيد طبقة وسيطرة ذوي السلطة والمناصب على مقدرات الدولة وثرواتها، وجد البيئة خصبة والطريق مفتوحاً ليضع رجله على دواسة الوقود حتى آخرها، نتج عنها بروز أحزاب وجماعات كانت تنتظر مثل هذه اللحظة التاريخية لتتسيد المشهد الذي ملامحه الحالية تؤكد أنه مشهد مرسوم منذ البداية ليكون القادمون الجدد أو المتسيدون للمشهد هم الرقم الصعب في معادلة تحقيق الأهداف من الفوضى الخلاقة، سواء كان هؤلاء القادمون الجدد أو الراكبون لموجة الأحداث مدركين أو مغيبي الوعي أنهم تقع عليهم التزامات يجب الوفاء كضريبة لحالة التمكين.
مضى عام 2018، وبقي لنا ما نحن فيه، وما علينا أن نتجرع صابه ونعاني عذابه، نسوّغ حلوه ومره، فمر حلو بذوق فريق وحلوه مر بذوق آخر، ومصائب قوم عند قوم فوائد؟! وهكذا هم الخلق في الحروب يتساقون كؤوس الردى ويتبادلون سداد ثارات الدم والأيام دول ”يوم لك ويوم عليك”… ولكنها بمجملها أيام ترتد علينا نحن العرب والمسلمين وبالاً وضعفاً ونكالاً، وترتد كذلك على بلداننا وأمتنا الإسلامية وعلى الدين الإسلامي، وعلى القيم وما قد يتبقى للأجيال العربية القادمة على الخصوص من وجود وحقوق وأمل.
وهذا الوضع كله ينعكس على الكبار والصغار… ينعكسُ مآسٍ خاصة وعامة، وعلاقات اجتماعية مضطربة، وأكثر من صعبة، وأكثر من خطرة… وينعكس على التربية والتعليم، في بلدان تحتاج إلى الإعمار، والتقدم، على أسس من العلم والتربية والأخلاق… ومن المعروف ما يجره ذلك، وما سيجرّه اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً و… و… ولا أتكلم عما سيجرّ سياسياً، فتلك الداهية، الدّهياء.
فهل تحميل البلدان والمجتمعات المعنية، تكاليف الحروب، وتبعاتها، ونتائج هذه الأوضاع الاجتماعية والإنسانية كافة، وانعكاسات الحرب، وكل ذلك مستقبلاً، على تلك البلدان، إذا ما وصلت لحلول وسلام… هل يكون هذا كله يا تُرى أسهل، وأرحم، وأشرف، وأهم… من أن نضعه بسَعَته في مدارات إدراكنا، وأمام أنظارنا… فنختار وقف الحرب، ووقف الانهيار، واللجوء إلى حلول سلمية، وطنية، قومية، إنسانية… تجنب بلداناِ وشعوباً تلك التكاليف الباهظة، والنتائج المرّة، وتبقي لديها جهداً وأملاً وطاقة وإمكانية، تصبّ باتجاه استنقاذ ما يمكن استنقاذه، وتلتفت إلى الحاضر المدمَّر، إلى المستقبل، إلى السلام، والوئام والتعاون، إلى الأوطان والإيمان والإنسان… وتواجه ما جلبته العنجهية والحرب: ”خراب الدِّيار، وعودة الاستعمار؟!. والذين يُصرّون على رفضِ كل حل ممكن للأزمات والمشكلات، ويَزجون ملايين الناس في صنوف المعاناة، هم عبئ على الشعوب، والإنسانية، والحياة، وهم الأزمات والمشكلات.
إذ أنه في حقيقة الأمر، يوجد لكل أزمة، ولكل مشكلة حل، غير القتل والتأسيس للمآسي والكراهية والأحقاد، ولأنواع الثأر والانتقام… والحل يكمن في العقل والخلق والفضل. من الواقعي والمنطقي والعلمي، أنه حين تصفو الأنفس ترى ذاتها، وترى غيرها، وتعرف ما لها وما عليها، وتكون مرآة نقيَّة، بأبعادٍ متعدّدة، ترى ما يُرى، وتقرأ احتمالات ما قد يكون، وما قد يُرى… أمَّا حين تتعكرُ وتغدو العَكَرَ، والمستنقعَ الآسنَ، ومقبرة الفِكَرِ… فإنها لا تَرى من ذاتها ومن الآخرين إلا بائس الرؤية مغلوطَها، ولا تَرى حتى دمها الذي يوغلُ في دم الآخر، فيريقه أو يُراقُ به. إنه حين يصفو الماء نرى قعر الإناء، وإن النظرة الفاحصة لقعر العين السليمة تُري الحكيمَ صفاء النفس، وقد يَقرأ القارئ فيها، بعض صفحاتها الرائعة.
فماذا نقول اليوم، في زمن هو المحن، وكيف نخرج من فتنة ابتلينا بها، ونتخلص ممن يقتلوننا ليحررونا، وليحموا الوطن منا؟! إن ما يفعله فينا ”أهل السلطات والمعارضات”، أمراء الحرب وتجارها وساستها ومن وراءهم… أصبح فيه موت الحياة، والحياة موتاً… ولا أجد ما أقول في هذا، حتى أنني لا أجد طعماً لأي قول، لأن كل الكلام لا يصف ولا ينصف حالة من تلك الحالات المأساوية التي تغرقنا فيها ويستغرقنا مدها وجزرها، وتلفنا بلاويها… ولا يقدم أقل إيحاء بعمق المشاعر التي تنطوي عليها أفعال من هذه الأنواع.
دُعاة الحروب، والقتل، واستخدام القوة للقوة، والشرِّ للشر، هم عَكَر مطلَق، وبصر بلا بصيرة، وهم عبء على علاقات الناس، وعلى أخلاقيهم وقيمهم، وعلى حياتهم… ويجب ألا ينقادَ الناسُ لهم، لأن في ذلك تَهلُكة، وإطاعة للمخلوق في معصية الخالق، ففتنة الحرب قتل، والفتنة أشدُّ من القتل، وفيها تَهلكة، وقد نهانا اللُه، سبحانه وتعالى، عن أن نلقيَ بأنفسنا إلى التَّهلُكَة:﴿ وَأنفِقوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾-سورة البقرة.
على أي حال، ورغم حالة البؤس والتشرذم والانقسامات الحادة التي يعيشها العرب، تبقى الفرصة قائمة لإعادة لم الشمل والتصدي لهذا التفسخ لو كانت هناك نيات طيبة وتبقى الخطوة الأولى على الأقل البدء بإصلاح الجامعة العربية ورفع الوصاية عنها من طرف بعض الدول الخليجية والاتفاق على حزمة من الأولويات العربية في مقدمتها عدم تدخل الآخرين في الشأن العربي الداخلي، ومعارضة طلب التعاون مع الخارج الإقليمي أو الدولي للانقضاض على أخ أو شقيق في الداخل، وعلى أن تكون أولوية العمل العربي موجهة باتجاه قضية فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى بدلاً من تجاهل أنظمة عربية لهذه القضية ووضعها على الرف.
وإذا كان لنا أن نطمع في التمنيات ونحن نستقبل العام الجديد، فلنا أن نقف عند التمني الذي يحرر الأسرى الفلسطينيين، ويعيد الياسمين إلى دمشق، ويزيل كآبة الشحة والضمور من أنهار دجلة والليطاني والنيل وكل الأنهار العربية التي بدأت تشيخ جفافاً، وأن نسمع هدير بردى الشام مواويل وذكريات، وأن تتزين شجرة الأرز اللبنانية بروح الألفة لتعيد ترتيب أولويات كتل سياسية ما زالت تلهج ليل نهار بأنها الأسمى والأحسن، وأن يكون للريف العربي حظوته بالمزيد من القرى العصرية، وأن يعلن الكثير من اللصوص وقطاع الطرق والقتلة براءتهم من ماضيهم وأن نبتعد من ثقافة العويل!